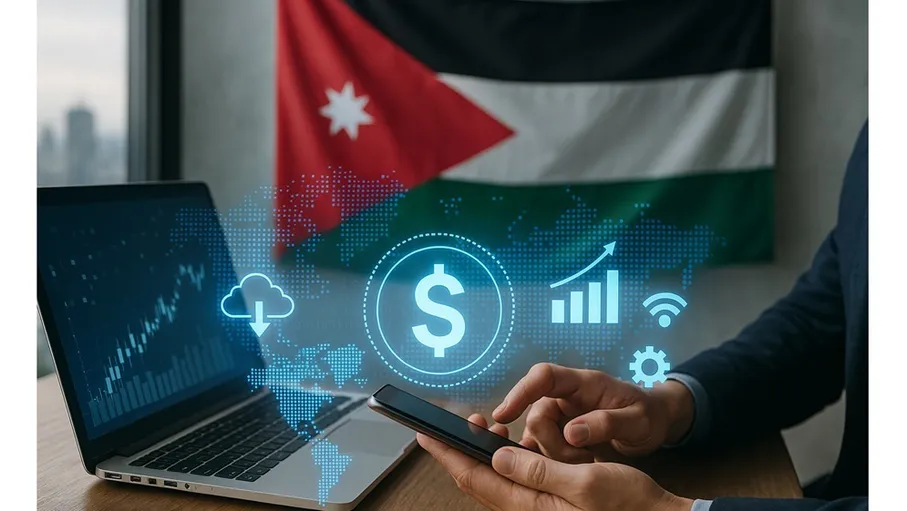لم تعد الخطيئة سياسية فقط، بل أخلاقية، دينية، مجتمعية. أشعر بثقل دائم: على كلماتي، على خطواتي، على ما أقوله، وعلى ما لم أقله حتى، كل ما حولي يُعيد إنتاج الطاعة: المعلم، الشيخ، الأخ، المسؤول، الرفيق، وحتى “اللاأحد” على وسائل التواصل.
في ذروة أحداث السويداء ظهرت لافتات ورقية صغيرة على جدران دمشق، تداولها ناشطون وناشطات على وسائل التواصل الاجتماعي، كُتب عليها: “الهمجية ما بتمثلنا… نحنا الشوام، وكل المحبة والاعتذار لأهلنا بالسويدا، السويدا جزء أصيل من هالبلد ومن روحها”. لاحقًا، انتشرت صور أخرى تحمل عبارات مشابهة:”من دمشق وريفها للشام وجبلها، نحنا معكن ضد كل قتل، كل ظلم، كل تهجير”.
جاءت هذه الحملات رداً على ما تعرضت له السويداء من هجمات على يد عناصر مسلحة محسوبة على العشائر، وتدخّل سلطة دمشق بحجة “فض النزاع”، ما أدى إلى مجازر شهدتها المدينة المحاصرة.
سبق هيمنة السلاح المنفلت هذه ما تعرض له الساحل السوري من مجازر أشارت إليها التقارير الحقوقية والصحافية. فانفلات السلاح في سوريا لم يعد محطّ جدل، الفضاءات العامة مليئة بالمظاهر المسلحة وتتكرر الاعتداءات بالسلاح على المدنيين سواء لأسباب سياسية وطائفية أو بهدف ارتكاب جرائم سرقة وقتل، تقابل ذلك مظاهر هيمنة رمزية ذات طابع إسلامي متشدّد.
في خضم هذه الصراعات التي تصل حدّ العنف، تبرز تساؤلات عدة، أبرزها: لماذا يعلو صوت التحريض ويخفت صوت التضامن؟ ولماذا نعود، بعد أكثر من عقد، إلى تقنيات تشبه بدايات الثورة السورية؟، والمقصود حملات تضامن خفية سرية، من دون أوجه، تشابه في شكلها ما كان الناشطون يقومون به في عهد النظام البائد.
جذور الخوف: تركة نظام الأسد
ما زال الخوف يحكم الكثير من السوريين، خصوصاً في ظل العنف المسلح في سوريا، لكن هذا الخوف مصدره الأول متجذّر، يعود إلى نظام لم يمت، بل أعاد ترتيب أدواته. منذ اللحظة التي تسلّمت فيها السلطة الجديدة مقاليد الأمور، بدأ القمع يتسلل مجددًا: حملات اعتقال في ريف حمص الغربي، عودة الحواجز ومهانة “الهوية”، وانتهاكات مصوّرة على وسائل التواصل الاجتماعي كطقوس إذلال علني.
ما بدأ كحالات فردية، تصاعد إلى مجازر جماعية في آذار/ مارس، راح ضحيتها 1479 شخصًا بحسب وكالة رويترز، ثم إلى حصار السويداء، وعودة مناخ العقاب الجماعي. وفي تموز/ يوليو وحده، وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 109 حالات اعتقال واحتجاز تعسفي، بينها 12 حالة نفذتها “الحكومة المؤقتة” في مناطق سيطرتها.

جذور الخوف: أسلمة الفضاء العام
الخوف الثاني أحدث، لكنه أكثر مراوغة. يأتي من “فتح دمشق”، لا كتحرير، بل كاحتلال رمزي للمجال العام، سيارات دعوية، ملصقات “الحشمة”، خطب دينية تتسرّب إلى قلب المؤسسات. شيخ يتحول إلى مسؤول، وامرأة تُمحى من المشهد الرسمي. من تعليمات مدير مستشفى المواساة التي فرضت جلوس العاملات في القسم الخلفي من باصات الموظفين، إلى الفصل بين الجنسين في أماكن عامة، تبدو السلطة وكأنها تمارس وصاية مزدوجة: ذكورية سلطوية وأسلمة سياسية، تُعيدان إنتاج مناخ خانق، طارد، مألوف.
ناهيك بالتوظيف القانوني لجرائم “إهانة هيبة الدولة” والتهم التي كان يستخدمها النظام السابق. باختصار، “الإدارة الجديدة” ورثت بنية قمعية قانونية، ما زالت عاجزة عن تفكيكها، وفي بعض الأحيان، تستعين ببعض الفاعلين ضمنها، سواء للسلم الأهلي أو التعافي الاقتصادي، هذا بالذات، يزيد من طبقات الخوف القديم، أي عودة بعض “اللاعبين القدامى” إلى مزاولة “مهماتهم”.

الحصار الذي لا يُرى: عن القمع الأفقي
أنا بتول، كاتبة سورية أنحدر من عائلة ثارت على النظام عام 2011، عرفنا الحصار، عايشناه، نجونا منه، اختبرناه بكل أشكاله. لكنني لم أشعر به كما أشعر الآن. فهذا ليس حصارًا خارجيًا، بل داخلي، يومي، حاضر في التفاصيل، لم تعد العين المراقبة تأتي من “الأعلى” فقط، بل صارت تتكاثر: في البيت، في السوق، في المسجد، وفي الشاشات الصغيرة التي نكتب عبرها ثم نتراجع.
لم تعد الخطيئة سياسية فقط، بل أخلاقية، دينية، مجتمعية. أشعر بثقل دائم: على كلماتي، على خطواتي، على ما أقوله، وعلى ما لم أقله حتى، كل ما حولي يُعيد إنتاج الطاعة: المعلم، الشيخ، الأخ، المسؤول، الرفيق، وحتى “اللاأحد” على وسائل التواصل.
لم نعد في دولة بوليسية، بل في مجتمع بوليسي، حيث كل فردٍ قد يتحوّل إلى نسخة مصغرة عن السلطة، بعد حادثة الاعتداء على المحتجّين أمام البرلمان. لم أعد أشعر بالأمان لرفع صوتي في الشارع. هذا الإحساس لا يخصني وحدي، هو شعور مشترك يتسرّب إلى أحاديث الناس، ويجد جذوره في مناخ من انعدام الثقة والإكراه الخفي.

العودة إلى الهمس؟
في هذا التسرّب السلطوي، لا أرى في العودة إلى الهمس نوستالجيا إلى 2011، بل ردّ فعل طبيعياً. ولهذا بدأت تتشكّل حملات صغيرة، متباعدة جغرافيًا، متقاربة روحيًا: صور مكتوبة بخط اليد، وجوهٌ مخفية، رسائل بلا توقيع، وعبر الفضاء الرقمي، تنوعت التفاعلات: بين التهكم، التقليل، الهجوم، واغتيال الرموز المعنوية، اغتيال يؤكد مخاوف المتضامنين سرًا.
تواصلت مع “لينا” (اسم مستعار)، ناشطة في حملة “من الريف إلى الجبل”، سألتها: لماذا بالسر؟، فأجابت: “فيديو تالا الشوفي وهي تعزف لا يفارقني. لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن قتل وجه كهذا. لكن تضامني العلني سيجعلني فريسة للترهيب ويضعني في معسكر سياسي. لذلك لجأت الى الورقة المعلقة. لا بيان سياسي، بل صوت إنساني، محاولة لبناء جسر، لأقول للخائفين مثلي: لستم وحدكم”.
هذه المحاولات الفردية على الرغم من انتشارها كـ”تريند” إلا أنها لا تلبث أن تتلاشى أمام الجهود المنظمة الرسمية وغير الرسمية للسيطرة على الفضاء العام في سوريا، أو على الأقل، في مناطق حكم “الإدارة الجديدة”، سلطة الترهيب والتأديب الذي يمارسها أفراد لا يمكن ضبطها، وهي بالذات تعزز الخوف، الذي يتضاعف في حالات النساء، أمام الأخبار شبه اليومية عن حالات الخطف والاختفاء وغيرها، ما يدفع النساء الى التلاشي، والراغبين في الحوار الى التراجع نحو الصمت والخفاء، إذا رفع أحدهم سيفاً بوجه محتجين صامتين، فهل الكلمة أقدر على مواجهة السيف؟ في سوريا، الإجابة عن هذا السؤال مأساوية!
السلطة والمتواطئين على الصمت
لا تستهدف هذه الحملات الإدارة السياسية وحسب، بل تُقاوم بنية القمع الأفقية: صمت الجماعة، رقابة الجار، تواطؤ المراقب، والعزلة النفسية. ليست هذه استعادة لزمن 2011، بل اشتقاق منه. الأدوات ذاتها (المنشور، الورقة، التوقيع المجهول)، لكن بديناميات جديدة.
في 2011، كان الصوت موجّهًا الى السلطة. أما الآن، فهو موجّه الى الجماعة، الى الجار، الى الصديق. فما يحصل ليس خوفًا بالمعنى الحرفي، بقدر ما هو حالة ترهيب متبادل، تُسعّرها نيران مزدوجة: خطاب كراهية رسمي وتحريض علني، يقابله غياب مطلق للمحاسبة يمنح المعتدين غطاءً للعنف.
وبالتوازي، تنشأ شراسة في الدفاع عن السلطة لدى قسم من الشعب، لا تنطلق من الولاء بل من شعور بالمظلومية، يرى في هذه السلطة ممثله الوحيد وحاميه. هذا الشكل من الولاء القهري، هو أحد تجليات ما يُعرف بـ”تطبيع القمع”، حيث يُعاد إنتاج الاستبداد من جماعة ترى فيه مرآة لنجاتها. هذا المناخ، الذي يفتت المجتمع من الداخل، هو نتاج مباشر للاستثمار في هذه المظلومية، وما كان ليزدهر لولا الغياب التام لأي مظهر من مظاهر العدالة الانتقالية.
قد تبدو ورقة معلّقة في شارع جانبي فعلًا ساذجًا في وجه سلطة ترتكز على الحديد والنار. وقد يتهكم الساخر: “وهل تسقط الأنظمة بالورق؟”، لكن القيمة الحقيقية لهذه الأفعال لا تُقاس بقدرتها على التغيير الفوري، فهي ليست بديلًا عن المواجهة، بل شرطٌ يسبقها. قيمتها تكمن في فضحها استمرارية القمع، وفي كونها فعلًا تكتيكيًا دقيقًا في هذه المرحلة هدفه المثالي: إعادة بناء الثقة المفقودة بين الناس، تلك الثقة التي هي المادة الخام لأي عمل جماعي مستقبلي.
هذه الحملات تُفكّك التمثيل الجمعي القائم على التحريض، تكسر العزلة الشعورية، تعيد بناء اللغة. لكن الأهم، أنها تؤكد أن المعركة التي انتهت هي معركة الصوت العالي والمواجهة المفتوحة في الشوارع. أما المعركة التي يجب أن تبدأ الآن، فهي أشد تعقيدًا وصمتًا، إنها معركة استعادة المجال الاجتماعي والمدني من “المجتمع البوليسي”، معركة نسج خيوط الثقة من جديد، ومعركة بناء جماعات قادرة على التفكير والعمل المشترك خارج عين الرقيب.
نهايةً قبل أن نعود إلى الشارع، علينا أولًا أن نضمن أننا حين نصل إليه، لن نكون وحيدين مرة أخرى، أو على الأقل… لن تُرفع بوجهنا السيوف!.